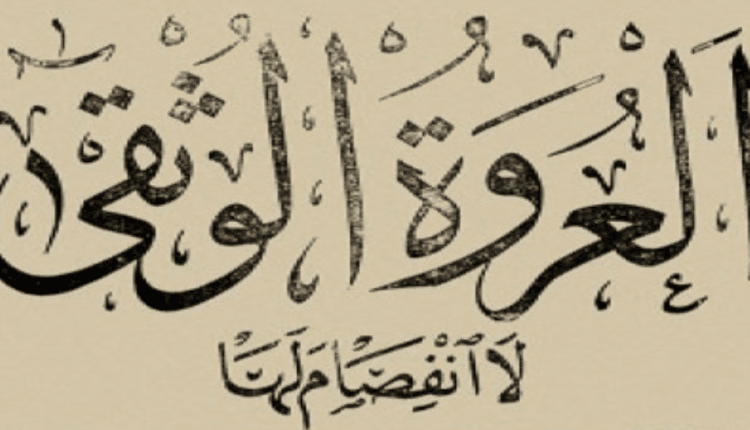إنَّ في ذلك لَذِكرى لِمَن كان لهُ قلبٌ أو ألْقى السَّمْع وَهُو شَهيدٌ
خلق اللهُ الإنسان عالماً صناعياً ويسّر له سبيل العمل لنفسِه، وهَداه للإبداع والاختراع وقدّر له الرزق من صنع يديه، بل جعله ركن وجوده ودعامة بقائِه فهو على جميع أحواله من شيق وَسّعة وخشونة ورفاهة. وتبدو حضارة صنيعة أعماله أقواته من معالجة الأرض بالزراعة أو قيامه على الماشية وسرابيله وما يقيّه الحرّ والبرد والوجى من عمل يديّه نسجاً أو خصفاً، وأكنانه ومساكنه ليست إلا مظاهرة تقديره وتفكيره وجميع ما يتفنن فيه من دواعي ترفه ونعيمه إنما هي صورُ أعماله ومجالي أفكاره. ولو نفض يديه من العمل لنفسه ساعة من الزمان وبسط أكفه للطبيعة ليستجديها نفساً من حياة، لشحّت به عليه بل دفعته إلى هاوية العدم وهو في صنعه وإبداعه محتاج إلى أستاذ يثقفه وهادٍ يُرشده، فكما يعمل لتوفير لوازم معيشته وحاجات حياته يعمل ليعلم كيف يعمل وليقتدر على أن يعمل فصنعته أيضاً من صنعه فهو في جميع شؤونه الحيوية عَالَم صناعيّ كأنه منفصل عن الطبيعة بعيدٌ عن آثارها، حاجته إليها كحاجة العامل لآلة العمل، هذا الإنسان في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه.
دَعهُ في هذه الحالة وَخُذ طريقاً من النظر إلى أحواله النفسّية من الإدراك والتعقل والأخلاق والملكات والانفعالات الروحية تجده فيها أيضاً عالمَاً صناعياً، شجاعته وجبنه وصبره، كرمه وبخله، شهامته ونذالته، قسوته ولينه، عفته وشرهه، وما يشابهها من الكمالات والنقائص جميعها تابع لما يصادفه في تربيته الأولى وما يودع في نفسه من أحوال الذين نشأ فيهم وتربى بينهم مرامي أفكاره ومناهج تعقله ومذاهب ميله ومطامح رغباته ونزوعه إلى الأسرار الإلهية أو ركونه إلى البحث في الخواص الطبيعية، وعنايته باكتشاف الحقيقة في كلّ شيء أو وقوفه عند بادئ الرأيّ فيه وكل ما يرتبط بالحركات الفكرية، إنما هو ودائعٌ اخترنها لديه الآباء والأمهات والأقوام والعشائر والمخالطون. أما هواء المولد والمربى ونوع المزاج وشكل الدماغ وتركيب البدن وسائر النواحي الطبيعية، فلا أثر له في الأعراض النفسّية والصفات الروحانية إلا ما يكون في الاستعداد والقابلية على ضعف في ذلك الأثر؛ فإنّ التربية وما ينطبع في النفس من أحوال المعاشرين وأفكار المثقفين تذهب به كأن لم يكن أودع في الطبع. نعمْ إنّ أفكاراً تتجدد ومعقولات عن أخرى لتولد وصفات لسمو وهمماً تعلو حتى يفوق اللاحقون فيها السابقين ويظن أنّ هذا من تصرف الطبيعة لا من آثار الاكتساب. ولكن الحق فيه أنّه ثمرة ما غُرس ونتيجة ما كسب فهو مصنوع يتبع مصنوعاً؛ فالإنسان في عقله وصفات روحه عالم صناعي.
هذا مما لا يرتاب فيه العقلاء والسذّج. ولكن هل تذكرت مع هذا أنّ الأعمال البدنية إنما تصدرُ عن الملكات والعزائم الروحية، وأنّ الروح هيّ السلطان القاهر على البدن. أظنك لا تحتاج فيه إلى تذكير لأنّه مما لا يغرب عن الأذهان إنما قبل الدخول في موضوعنا أقول كلمة حق في الدين ولا أظن مُنكِراً يجحدها: إنّ الدين وضعٌ إلهيٌّ، ومعلمه والداعي إليه البشر، تتلقاه العقول عن المبشّرين المنذرين، فهو مكسوبٌ لمن لم يختصهم بالوحي، ومنقولٌ عنهم بالبلاغ والدراسة والتعليم والتلقين، وهو عند جميع الأمم أول ما يمتزج بالقلوب ويرسخ في الأفئدة وتصبغ النفوس بعقائده وما يتبعها من الملكات والعادات ولتمرّن الأبدان على ما ينشأ عنه من الأعمال عظيمها وحقيرها، فَلَه السلطة الأولى على الأفكار وما يطاوعها من العزائم والإرادات، فهو سلطانُ الروح ومرشدها إلى ما تدبّر به بدنها. وكأنّما الإنسان في نشأته لوح صقيل وأول ما يخط فيه رسم الدين ثم ينبعث إلى سائر الأعمال بدعوته وإرشاده. وما يطرأ على النفوس من غيره فإنما هو نادر شاذ. حتى ولو خرج مارقٌ عن دينه لم يستطع الخروج عما أحدثه فيه من الصفات بل تبقى طبعته فيه كأثر الجرح في البشرة بعد الاندمال.
وبعد هذا، فموضوع بحثنا الآن الملّة المسيحية والملّة الإسلامية. وهو بحثٌ طويل الذيّل. وإنما نأتي فيه على إجمال يُنبئك عن تفصيل. إنّ الديانة المسيحية بُنيت على المسالمة والمياسرة في كلّ شيء، وجاءت برفع القصاص واطراح المُلك والسلطة، ونبذّ الدنيا وبهرجها، ووعظت بوجوب الخضوع لكلّ سلطان يحكم المتدينين بها، وترك أموال السلاطين للسلاطين، والابتعاد عن المنازعات الشخصية والجنسية بل والدينية. ومن وصايا الإنجيل: مَنْ ضَرَبك على خدك الأيمن فَأَدِرْ له الأيسر. ومِنْ أخباره أنّ الملوك إنما ولايتهم على الأجساد وهي فانيّة، والولاية الحقيقية الباقية على الأرواح وهي لله وحده. فمن يقف على مباني هذه الديانة ويلاحظ ما قلنا من أنّ الدين صاحب الشوكة العظمى على الأفكار مع ملاحظة أنّ لكلِ خيال أثراً في الإرادة، يتبعه حركة في البدن على حسبه، يعجب كل العجب من أطوار الآخذين بهذا الدين السّلمي، المنتسبين في عقائدهم إليه. فإنهم يتسابقون في المفاخرة والمباهاة بزينة هذه الحياة وَرَفَه العيش فيها، ولا يقفون عند حدّ في استيفاء لَذاتها، ويسارعون إلى افتتاح الممالك والتغلب على الأقطار الشاسعة ويخترعون كل يوم فنّاً جديداً من فنون الحرب، ويبدعون في اختراع الآلات الحربيّة القاتلة ويستعملها بعضهم في بعض ويصولون بها على غيرهم، ويبالغون في ترتيب الجيوش وتدبير سوقها في ميادين القتال، ويصرفون عقولهم في أحكام نظامها حتى وصلوا غاية ما صار بها الفنّ العسكري من أوسع الفنون وأصعبها، وأنّ أصول دينهم صارفة لعقولهم عن العناية بحفظ أملاكهم فضلاً عن الالتفات إلى طلب غيرها.
الديانة الإسلامية وُضع أساسُها على طلب الغلبة والشوكة والافتتاح والعزة، ورفض كل قانون يخالف شريعتها، ونَبْذ كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية على تنفيذ أحكامها، فالناظر في أصول هذه الديانة ومن يقرأ سورة من كتابها المنزل يحكم حكماً لا ريب فيه بأن المعتقدين بها لا بدّ أن يكونوا أولّ ملّة حربيّة في العالم، وأن يسبقوا جميع الملل إلى اختراع الآلات القاتلة، وإتقان العلوم العسكرية والتبحر فيها يلزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء وجرّ الأثقال والهندسة وغيرها. ومن تأمل في آية {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} أيقن أنّ مَن صبغ بهذا الدين فقد صبغ بحبّ الغلبة وطلب كل وسيلة إلى ما يسهل له سبيلها والسعي إليها بقدر الطاقة البشرية، فضلاً عن الاعتصام بالمنعة والامتناع من تغلب غيره عليه، ومن لاحظ أنّ الشرع الإسلاميّ حرم المراهنة إلا في السباقة والرماية انكشف مقدار رغبة الشارع في معرفة الفنون العسكرية والتمرن عليها. ولكن مع كل ذلك تأخذه الدهشة من أحوال المتمسكين بهذا الدين لهذه الأوقات إذ يراهم يتهاونون بالقوةِ ويتساهلون في طلب لوازمها وليست لهم عناية بالبراعة في فنون القتال ولا في اختراع الآلات، حتى فاقتهم الأمم سواهم فيما كان أول واجب عليهم واضطروا لتقليدها فيما يحتاجون إليه من تلك الفنون والآلات، وسقط كثير منهم تحت سلطة مخالفيهم واستكانوا لها ورضخوا لأحكامها. ومن وازن بين الديانتين حار فكره كيف اُخترع مدفع “الكروب” و”المتراليوز” وغيرهما بأيدي أبناء الديانة الأولى قبل الثانية، وكيف وُجدت بندقية “مارتين” في ديار الأولين قبل وجودها عند الآخرين، وكيف أحكمت الحصون ودرعت البواخر وأخذت مغالق البحار بسواعد أهل السلامة والسلم دون أهل الغلبة والحرب.
لِمَ لا يَحارُ الحكيم وإن كان نطاسياً. لِمَ لا يقف الخبير البصير دون استكناه الحقيقة. هل القرون الخالية والأحقاب الماضية لم تكن كافية لرسوخ الديانتين في نفوس المتمسكين بعراهما؟ هل نبذت كل ملّة من الملّتين عقائد دينها ظهرياً من أجيال بعيدة؟ هل اقتصر النصارى في دينهم على الأخذ بشريعة موسى واقتفى سيرة يوشع بن نون؟ هل تخللت بعض آيات الإنجيل من حيث يدري ولا يدري بين الخطب والمواعظ التي تُتلى على منابر المسلمين أو ألقى شيء منها في أماني معلميهم وناشري شريعتهم عندما يتربعون في محافل دروسهم! هل تبدلت سنة الله في الملتين؟ هل تحول مجرى الطبيعة فيهما؟ هل استبدت الأبدان فيهما على الأرواح أو وجد للأرواح دبير سوى الفكر والخيال، أو انفلتت الأفكار من سلطة الدين أو تعاصت النفوس عن الانتقاش بنقشته وهو أول حاكم عليها وأقوى مؤثر فيها. هل تتخلف العلل عن معلولاتها؟ هل تنقطع النسب بين الأسباب ومسبباتها؟ ماذا عساه يُرشد العقول إلى كشف المساتير وحلّ المعميات؟
أَيُنسب هذا إلى اختلاف الأجناس وكثير من أبناء الملّتين يرجعون إلى أصول واحدة ويتقاربون في الأنساب الدانية. أَيُنسب إلى اختلاف الأقطار وكثير من القبيلين يتشابهون في طبائع البلدان ويتجاورون في مواقع الأمكنة. ألم يصدر من المسلمين وَهُم في شبيبة دينهم أعمال بهرت الأبصار وأدهشت الألباب. ألم يكن منهم مثل فارس والعرب والترك الذين دخلوا الممالك واستووا على كرسيّ السيادة فيها. كان للمسلمين في الحروب الصليبية آلات نارية أشباه المدافع فزع لها المسيحيون وغابوا عن معرفة أسبابها. ذكر ملكام سرجم “إنكليزي” في تاريخ فارس أنّ محمود القزنوي كان يحارب وثنيّ الهند بالمدافع، وكانت هيّ الأسباب في انهزامهم بين يديه سنة 400 من الهجرة. وما كان المسيحيون لذلك العهد يعرفون شيئاً منها.
فأيّ عَوْن من الدهر أخذ بأيدي الملّة المسيحية فقدمها إلى ما لم يكن في قواعد دينها. وأيّ صدمة من صدماته دفعت في صدور المسلمين فأخرتهم عن تعاطي الوسائل لما هو أول مفروض في دينهم، مقام للحيرة وموضع للعجب. ويظنّ أن لا بدّ لهذا التخالف من سبب، نعم وتفصيله يطول.
ولكن نُجمل على ما شرطنا: أنّ الدين المسيحي إنما امتد ظله وعمّت دعوته في الممالك الأوربيّة من أبناء الرومانيين وَهُم على عقائد وآداب وملكات وعادات ورثوها عن أديانهم السابقة وعلومهم وشرائعهم الأولى. وجاء الدين المسيحي إليهم مسالماً لعوائدهم ومذاهب عقولهم وداخلهم من طرق الإقناع ومسارقة الخواطر لا من مطارق البأس والقوة، فكان كالطراز على مطارفهم ولم يسلبهم ما ورثوه عن أسلافهم. ومع هذا فإنّ صحف الإنجيل الداعية للسلامة والسّلم لم تكن لسابق العهد مما يتناوله الكافة من الناس، بل كانت مذخورة عند الرؤساء الروحانيين. ثمّ إنّ الأحبار الرومانيين لما قاموا أنفسهم في منصب التشريع وسنّوا محاربة الصليب ودعوا إليها دعوة الدين التحمت آثارها في النفوس بالعقائد الدينية وجرت منها مجرى الأصول ولحقها على الأثر تزعزع عقائد المسيحيين في أوربا، وافترقوا شيعاً وذهبوا مذاهب تنازع الدين في سلطته وعاد وميض ما أودعه أجدادهم في جراثيم وجودهم ضراماً وتوسعوا في فنون كثيرة وانفسح لهم مجال الفكر فيها، وكانت براعتهم في الفنّ العسكري واختراع آلات الحرب والدفاع مساوقة لبراعتهم في سائر الفنون.
أما المسلمون فبعد أن نالوا في نشأة دينهم ما نالوا وأخذوا من كلّ كمال حربي حظاً وضربوا في كلّ فخار عسكري بسهم، بل تقدموا سائر الملل في فنون المقارعة وعلوم النزال والمكافحة، ظهر فيهم أقوامٌ بلباس الدين وأبدعوا فيه وخلطوا بأصوله ما ليس منها، فانتشرت بينهم قواعد الجبر وضربت في الأذهان حتى اخترقتها وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت بعنانها عن الأعمال، هذا إلى ما أدخله الزنادقة فيما بين القرن الثالث والرابع وما أحدثه السُفسطائية الذين أنكروا مظاهر الوجود وعدوها خيالات تبدو للنظر ولا تثبتها الحقائق، وما وضعه كذبة النقل من الأحاديث ينسبونها إلى صاحب الشرّع صلى الله عليه وسلم ويثبتونها في الكتب وفيها السمّ القاتل لروح الغيرة، وأنّ ما يلصق منها بالعقول يُوجب ضعفاً في الهمم وفتوراً في العزائم، وتحقق أهل الحقّ وقيامهم بيان الصحيح والباطل من كل ذلك لم يرفع تأثيره عن العامة، خصوصاً بعد حصول النقص في التعليم والتقصير في إرشاد الكافة إلى أصول دينهم الحقّة ومبانيه الثابتة التي دعا إليها النبيّ وأصحابه، فلم تكن دراسة الدين على طريقها القويم إلا منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فئة معيّنة، لعلّ هذا هو العلّة في وقوفهم بل الموجب لتقهقرهم وهو الذي نعاني من عنائه اليوم ما نسأل الله السلامة منه.
إلا أنّ العوارض التي غشيت الدين وصَرَفَت قلوب المسلمين عن رعايته وإن كان حجابها كثيفاً لكن بينها وبين الاعتقادات الصحيحة التي لم يحرموها بالمرّة تدافع دائم، وتغالب لا ينقطع، والمنازعة بين الحقّ والباطل كالمدافعة بين المرض وقوة المزاج. وحيث إنّ الدين الحقّ هو أول صبغة صبغ الله بها نفوسهم ولا يزال وميض بَرقه يلوحُ في أفئدتهم بين تلك الغيوم العارضة فلا بدّ يوماً أن يَسطع ضياؤها ويقشع سحابُ الأغيان ومادام القرآن يُتلى بين المسلمين وهو كتابهم المنزّل وإمامهم الحقّ، وهو القائم عليهم يأمرهم بحماية حوزتهم والدفاع، حفظاً لحقوقهم وضناً بأنفسهم عن الذّل وملّتهم عن الضياع، وإلى الله تصيرُ الأمور.
باريس يوم الخميس 7 جمادى الثانية 1301/ 3 أفريل 1884